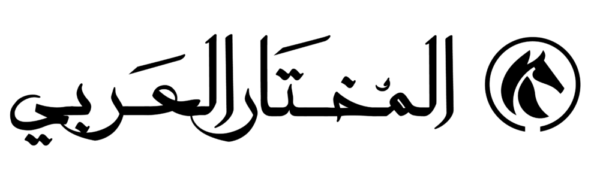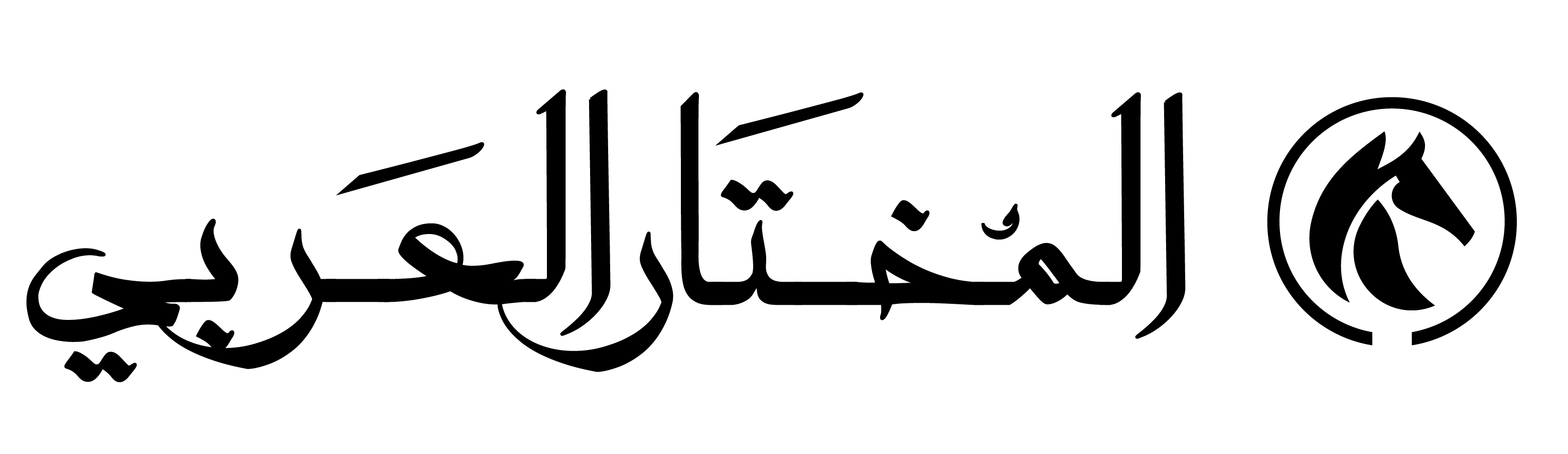تَكْسِيْرُ فَائِضِ القُوَّةِ
لا للمُغَالَبَةِ
لا للمُغَالَبَة مفهوم موجب لكلمة سالبة (المغالبة)، منهيًّا عنها بـ(لا)، ومع أنها أصبحت موجبة (لا للمغالبة) فإنها أصبحت واجبة القول؛ تجنبًا لسيادة الهيمنة والتهميش والقهر على حساب نظريَّة (استيعاب الآخر)، فـ(المغالبة) لغة الظالمين، الذين لا يَرَوْنَ مصلحةً إلا مصلحتهم، ولا يرون الآخرين إلا آخرين.
ومع أن (المغالبة) قيمة سالبة فإنها في بلادنا قد ورِّثَت من جيل إلى جيل؛ بها ينامون، وعليها يُصْبِحُون، وكأنها القَرِينُ الذي لا يفارق إلا من رحم ربُّك.
ولأن وراء كل علة معلول، فإن علة (المغالبة) عند العربي كانت بعلةِ استهدافه عبر التَّاريخ ظلمًا وعدوانًا، حتى أصبحت لغة (المغالبة) تجري في دمه؛ خوفًا وعصبيَّةً، وكأنه لم يبلغ الـمَدَنِيَّة يومًا، وكأنه لم يكن أصلَ الحضارة، وأهلَ الرسالة، وأصبحت لغة (المغالبة) لسان حاله، لا يطمئن إلا إليها، حتى أصبح لا يُفَرِّق بينها وبين الشجاعة؛ إذ أصبحت لغة (المغالبة) في أسواق العرب رائجةً؛ كونها عادةً اعتادوها، عليها يُرَبَّى النشء، وبها يتفاخرون؛ ولهذا تُعَدُّ الوصية الأولى التي يوصي بها الآباء أبناءهم يوم التحاقهم بمرحلة التَّعليم الابتدائي، ويا ليتها تموت